نحو ويستفاليا مشرقية
على مدار عقود طويلة يعيش الشرق الأوسط وأطرافه صراعات لا تنتهي، والإشكالية الأكبر أنّها أخذت أبعادًا قومية ودينية طائفية، صنعت بالتبعية إشكالية حقيقية في التعايش المشترك والتعاون، الذي من شأنه النهوض والارتقاء بحياة الأمم والانطلاق نحو التنمية.
والأزمة الأكبر كذلك، أنّ هذه الصراعات معروفة، لكن للأسف تغيب الإرادة التي يمكن أن تتبنى الرؤى التي تطرح لمعالجتها، وإن كانت محدودة والتي منها ما يطرحه المفكر العراقي الكبير الدكتور عبدالحسين شعبان، تحت ما أسماه “ويستفاليا مشرقية”.
ومن خلال هذا المصطلح يطرح شعبان ما يمكن وصفها بـ”رؤية علاجية” تحاول استلهام تجربة الدول الأوروبية التي انخرطت في حروب دينية دموية أتت على الأخضر واليابس وأزهقت ملايين الأرواح أدرك معها الأوروبيون أن حروبًا كهذه تعني الفناء للجميع ومن ثم كانت الحاجة إلى التعايش والحوار والتفاهمات التي جسدتها معاهدة صالح وستفاليا عام 1648.
محاضرة ألقاها الكاتب والمفكر والأكاديمي الدكتور عبد الحسين شعبان في القاهرة.
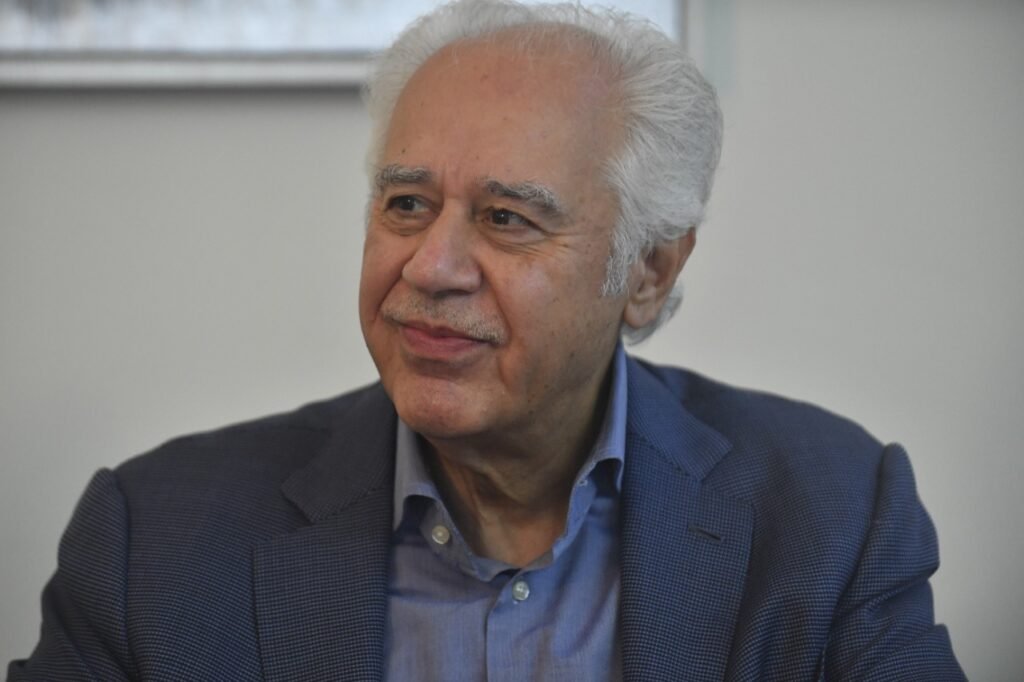
المدخل
لا يعني استخدام اسم “معاهدة” أو “صلح” ويستفاليا في العنوان هو استعارة نصية أو اقتباس حرفيّ أو تقليد ساذج لكل ما ورد في ويستفاليا، وإنّما الاسترشاد بالقواعد والمبادئ العامة التي حكمت الاتفاق لوقف الحروب والنزاعات المسلحة، التي شهدتها أوروبا لأسباب دينية وطائفية وأثنية، مع التأكيد على خصوصيات منطقتنا، واختلاف الظروف والأوضاع على مستوى كل بلد وعلى المستوى الإقليمي، ولكن تجربة ويستفاليا “الناجحة” تدعونا مثل أية تجربة عالمية للتأمّل والتفكير، وإعمال العقل لابتداع نموذجنا الخاص، آخذين بنظر الاعتبار المشتركات الكثيرة التي تجمع شعوب المنطقة وأممّها.
فأمم المنطقة وشعوبها تنتمي في الغالب إلى دين واحد، وإن تعدّدت لغاتها وقومياتها وعاداتها وتقاليدها، لكن ثمة مصالح مشتركة وتاريخ مشترك وعلاقات ثقافية واجتماعية واقتصادية وتجارية على جميع المستويات، بل وحتى مصائر مشتركة يكمّل بعضها بعضًا، تقتضي التوقّف عندها في الحديث عن ويستفاليا مشرقية.
ما هي ويستفاليا؟
المقصود ﺑـ”صلح ويستفاليا” أو “معاهدة ويستفاليا”، هو الاتفاق بين “دول أوروبا” ومقاطعاتها المختلفة، لوضع حدّ للاقتتال، حيث توصّل الفرقاء بعد قتال دام ثلاثين عامًا Thirty years War إلى توقيع اتفاق في العام 1648، وحرب الثلاثين عامًا هي سلسلة حروب وصراعات دموية وقعت معاركها ابتداءً من أوروبا الوسطى (1618 – 1648)، وخصوصًا في ألمانيا، وامتدّت إلى أراضي روسيا وإنكلترا وكاتالونيا “إسبانيا” وشمال إيطاليا وفرنسا، وهي حروب دينية وطائفية بالدرجة الأولى بين طائفتي البروتستانت والكاثوليك.
وقد شهدت أوروبا بسببها تدميرًا شاملًا، وانتشرت خلالها الأمراض والمجاعات، مثلما عرفت هلاكًا لملايين البشر، ويكفي أن نعرف، أنّ عدد النفوس في المقاطعات الألمانية، انخفض بنسبة زادت عن 30%، وأنّ هناك أكثر من 13 مليون ونصف المليون إنسان قضوا نحبهم، وقد انخفض عدد الذكور إلى النصف تقريبًا، الأمر الذي برّر للكنيسة ومراعاة للتوازن بين الجنسين، أن تسمح بالزواج للرجال بأكثر من امرأة بشروط معينة، بسبب العنوسة التي طالت ملايين النساء.
لقد كان إبرام معاهدة ويستفاليا، محطة أساسية لنشوء الدولة القومية (الدولة – الأمة)، ولاسيّما ضمان المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتعاون الاقتصادي والتجاري، لاسيّما بظهور الرأسمالية، إضافة إلى احترام الخصوصيات الدينية وحق ممارسة الشعائر والطقوس بحريّة.
وقد سبق حرب الثلاثين عامًا حرب المئة عام، التي استمرّت من الناحية الفعلية نحو 116 سنة (1337 – 1453)، وإن تخلّلتها فترات هدنة وسلام ومن أسبابها ادعاء الملوك الإنجليز، بأنّ العرش الفرنسي يعود إليهم، وبالطبع فإنّ هناك أسبابًا سياسية واقتصادية وشخصية كانت وراء اندلاع هذه الحرب الطويلة، ففي مجزرة واحدة راح ضحيّتها 35 ألف بروتستانتي فرنسي، على يد الكاثوليك المتعصبين في العام 1572.
ولم تكن هي الحرب الوحيدة، فقد دام الصراع والاحتراب بين الكنيسة اللوثرية والكنيسة الكاثوليكية خمسة قرون من الزمن، علمًا بأنّ عدد الذين يتبعون الكنيسة اللوثرية، يبلغ عددهم اليوم حوالي (80) مليون، فضلًا عن أتباع الكنيسة الكاثوليكية، الذين يزيد عددهم عن مليار و(200) مليون إنسان. وبعد هذا الصراع المديد، اتّفق الطرفان على وقف الاحترابات والنزاع التاريخي، واعتراف كلّ منهم بالآخر، وترك الخلافات للمحافل الأكاديمية والمجمّعات الثقافية ودراسات اللاهوت والدراسات الدينية، وألّا يستخدم في الحياة اليومية للمؤمنين من أتباع الكنيستين، من دون أن يكون لهُ تأثير على الشارع، ومن دون أن يكون لهُ انعكاسات سلبية على ميدان العلاقات الدولية.
ووفقًا لويستفاليا، تم الاعتراف بالحريّات الدينية وحق ممارسة الشعائر والطقوس دون الاعتراض عليها، واحترام استقلال الدول (الإمارات) المتفرّقة وسيادتها، ومنع أي اضطهاد ديني أو طائفي والتعاون فيما بينها، لإزالة الحواجز الاقتصادية والعوائق التجارية، وإنهاء الحروب الأهلية وعوامل التفتيت الداخلية، ووضع قواعد عامة أساسها عقد اجتماعي – قانوني جديد يستبعد أي إقصاء أو إلغاء.
في الحاجة إلى ويستفاليا
قد يكون من المفيد الحديث عن الحاجة إلى أكثر من ويستفاليا، وأقصد بذلك ويستفاليا عربية، وويستفاليا مشرقية، خصوصًا لما أصاب منطقتنا من اضطرابات وصراعات ونزاعات وحروب، سالت فيها دماء كثيرة وازهقت فيها أرواح ملايين البشر، بسبب عدم الإقرار بالتنوّع والتعددية وقبول الآخر، واحترام سيادته وحقه في تقرير المصير. وذلك على غرار ما حصل في صلح ويستفاليا. ويمكن التفكير أيضًا بويستفاليا إسلامية.
واستمرّ النظام الدولي ما بعد ويستفاليا حتى الثورة الفرنسية، أي نحو 140 عامًا من السلام، على الرغم من بعض الاختراقات. ولكن بعد هزيمة نابليون في معركة واترلو (18 حزيران / يونيو 1815) (بلجيكا – بروكسل)، أقيم نظام دولي جديد لعب فيه مترنيخ دورًا كبيرًا، وذلك في إطار ما عُرف بنظام فيينا في العام 1815، واستمرّ نحو 100 عام أيضًا، حتى الحرب العالمية الأولى 1914 – 1918، على الرغم من حدوث بعض التصدّعات فيه، خصوصًا في ثورات العام 1848، وقد تأسّس نظام فيينا 1814 – 1815 على قاعدة الحفاظ على الملكيات، وإعادة القديم على قدمه، أي المحافظة على ما هو قائم.
لماذا ويستفاليا؟
ثمّة أسباب تدعونا إلى تبنّي فكرة ويستفاليا مشرقية، وأساسها القناعة بأهمية المبادئ والقيم، التي يمكن استلهامها على صعيد كلّ بلد من بلدان المنطقة، أو على صعيد علاقات دول الإقليم مع بعضها البعض بوجود الأمم الأربعة: الترك، الفرس، العرب والكرد، ويمكن الحديث عن ويستفاليا إسلامية، وكتمهيد إلى ذلك، يحتاج الأمر إلى مصالحات وطنية في كلّ بلد من البلدان المعنية، لكي تُنتج وحدة وطنية قادرة على التفاعل مع محيطها الإقليمي، من أجل إنجاز تسويات مصالحات وحلول للمشكلات الإقليمية.
ولعلّ أسباب هذه الدعوة تكمن في: أولًا: التنكّر للحقوق القومية العادلة والمشروعة، وأهمّها حق تقرير المصير؛ وثانيًا: استمرار الصراع اللّاعقلاني: الشيعي – السني؛ وثالثًا: غياب مبدأ المساواة بين الأديان؛ ورابعها: استمرار مطامع الغرب وطغيانه في التعامل مع دول المشرق والنظر إليها كجزئيات وليس إقليمًا واحدًا، على الرغم من المشتركات التي تجمعها، والأكثر من ذلك، فإنّ ثمّة مشاريع تريد تقسيم دول المنطقة، بل تذريها إلى كيانات ودوليات وإمارات لتصبح جميعها “أقليات”، وحينئذ تكون إسرائيل “الأقلية” الأكثر تقدمًا تكنولوجيًا وعلميًا، ولاسيّما بالدعم الغربي.
وهنا يمكن التوقف عند مشروع برنارد لويس الذي نظّر إلى تقسيم البلدان العربية إلى 41 كيانًا أثنيًا ودينيًا وطائفيًا وسلاليًا وغيرها، وذلك في العام 1979، والذي تبناه الكونغرس الأمريكي في جلسة سريّة في العام 1983، واعتمد كخلفية مرجعية للاستراتيجية الأمريكية، والهدف منه إضاعة ملامح الهويّة العروبية بصعود الهويّات المصغرّة للمكرو دويلة، التي يُراد لها أن تتكرّس في الواقع العربي، لاسيّما بدفع شعوب وبلدان المنطقة إلى الاقتتال والاحتراب الداخلي والإقليمي، ليأتي لاحقًا مخطط التقسيم والتشظي لحصد النتائج.
ويعتبر لويس، أنّ العرب والمسلمين قوم فاسدون ومفسدون وفوضويون، ولا يمكن تحضّرهم، وإذا تركوا لحالهم، فسوف يداهمون العالم المتحضّر بموجات بشرية هائلة تدمّر الحضارات وتقوّض المجتمعات. الحلّ حسب رأيه هو في احتلالهم واستعمارهم وتدمير ثقافتهم الدينية، وإذا ما قامت واشنطن بهذا الدور فعليها أخذ التجربتين البريطانية والفرنسية بنظر الاعتبار، وعدم الوقوع في ذات الأخطاء التي وقعتا فيها.
إنّ هدف برنارد لويس هو إخضاع العالم العربي بعد تفكيكه والضغط على شعوبه للتخلص من عقائده الإسلامية الفاسدة، وهو الذي أسماه فوكوياما “نهاية التاريخ“، مثلما أطلق عليها هنتنغتون “صراع الحضارات“، لأنّ هناك مخاطر حسب وجهات النظر هذه على الحضارة والمدنية الغربية، المسيحية اليهودية، ولوضع العرب تحت السيطرة، لابدّ من استثمار تناقضاتهم وعصبياتهم وطوائفهم.
وتأكيدًا إلى ما ذهب إليه برنارد لويس، فإنّ بريجينسكي أشار عشية انتهاء الحرب العراقية – الإيرانية إلى أنّ “المعضلة التي ستعانيها الولايات المتحدة من الآن فصاعدًا، هي كيف يمكن تنشيط حرب خليجية ثانية تقوم على هامش الحرب بين العراق وإيران، وتستطيع أمريكا من خلالها تصحيح حدود سايكس بيكو؟
وكان ما قام به جورج دبليو بوش العام 2003 من تدمير العراق هو جزء من هذا المشروع، الذي حمل لاحقًا اسم “الشرق الأوسط الجديد” ، وهو ما كان قد دعا إليه شمعون بيريز في كتابه الشرق الأوسط الجديد[9] الذي أصدره بعد اتفاقيات أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية العام 1993، وكان بن غوريون رئيس وزراء إسرائيل عند التأسيس، هو أول من دعا إلى تجزئة المجزّأ من بلدان المشرق العربي، لتأمين وجود واستمرار “إسرائيل”، وذلك منذ العام 1953.
وكان كيسنجر هو الذي قال: علينا تشييد إمارة وراء كل بئر نفط، وذلك في العام 1975، وفضح تقرير بايك المقدّم إلى الكونغريس في العام 1976 مساعي الولايات المتحدة، للإطاحة بأنظمة عربية ومنع أي اتفاق بين سوريا والعراق، وتحريض كلّ منهما ضدّ الآخر.
ولكلّ ما تقدّم تصبح الدعوة لويستفاليا مشرقية فرض عين وليس فرض كفاية، وهي ضرورة واختيار في الآن، وهنا لا بدّ من البدء بالحوار والإيمان به طريقًا لحلّ المشكلات بصورة سلمية، على صعيد كلّ بلد وعلى الصعيد الإقليمي، إذْ ينبغي احترام تطلّعات المجموعات الثقافية كافة، سواء كانت دينية أم أثنية أم لغوية أم غير ذلك، وحقّها في التعبير عن نفسها في كيانية إنسانية “هويّة خاصّة”، ضمن إنسانيات عامة وجامعة “هويّة موحّدة” تتألّف من تواصل وتفاعل واشتباك إنساني اجتماعي واقتصادي وثقافي، يتجسّد في التلاقي والتفاهم والتعاون والاحترام المتبادل، واعتراف أحدهما بحقوق الآخر.
وبقدر كون الحوار مسؤولية، فلا بدّ من تنقية الذاكرة المشتركة مما يشوبها من أحقاد وإكراهيات ومرارات، تكدّست بمرور الأيام بسبب حروب أو نزاعات أو انتهاكات، والانطلاق إلى مفهوم التقارب والتشارك دون نسيان الماضي، الذي يمكن أن يكون منصّة للمراجعة ونقدًا للتجربة، لمنع تكرارها من جهة والاستفادة من دروسها التاريخية من جهة أخرى، وصولًا لتحقيق مفهوم جديد للأمن الخاص بالمجاميع الثقافية، سواء على صعيد كل بلد بتنوّعه الثقافي دينيًا وأثنيًا وسلاليًا ولغويًا، أو على صعيد أمم المنطقة ودوّلها وشعوبها، بهدف استنهاض الجانب الحضاري من الهويّة الخاصة، لكل مجموعة ثقافية أو لكل مجتمع ومن الهويات المشتركة ، لاسيّما للأمم والشعوب بهوياتها العامة.
الحوار هو مسار طويل لتحقيق السلم المجتمعي في كل بلد، وعلى مستوى البلدان والشعوب عمومًا، وهو الوجه الآخر لمواجهة تحدّيات التعصّب ووليده التطرّف ونتاجهما العنف والإرهاب، لاسيّما حين يكون هذا الحوار معرفيًا وثقافيًا وجزءًا من إيمان بالانتماء لهويّة جامعة على المستوى الوطني، وهويّة مشتركة على مستوى شعوب ودول الإقليم.
ويستفاليا والتجربة الكونية: الصراع اللوثري – الكاثوليكي
ثمّة تجربة تاريخية وراهنة تتعلّق بالصراع اللوثري الكاثوليكي ومدخلات حواره ومخرجاته، وهي تجربة غنيّة تمتدّ لخمسة قرون، ولكي نعرف قيمة الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه نستعيد مقولة “100 عام حوار أفضل من ساعة حرب“، وهو ما ينطبق عليه تمامًا، فمنذ ما يزيد عن 500 عام انطلق الراهب الألماني مارتن لوثر في مهاجمة صكوك الغفران، التي كان البابا ليو العاشر يصدرها لمغفرة الخطايا، لتكون شفيعًا للمسيحيين الذين يحصلون عليها لدخول الجنّة.
حينها كتب لوثر 95 بندًا مضادًّا لتلك الصكوك، وحاول تعليقها على أبواب كنيسة فيتنبرغ بألمانيا، فردّ البابا عليه بإلقاء الحُرم الكنسي، وكان من جرّاء ذلك، ولصراعات كاثوليكية – بروتستانتية أخرى، أن نشبت حروبًا دينيّة وطائفية دامية استمرّت عقودًا طويلة من الزمن، ارتُكبت فيها أبشع المجازر، وذهب ضحيّتها ملايين البشر.
وبعد 5 قرون على ذلك الخلاف التاريخي بين الكاثوليكيين واللوثريين، تمّ التوصّل إلى اتفاق ينهي الخلاف ويضع حدًّا للنزاع، وذلك في 31 تشرين الأول / أكتوبر 2016 ، حيث نظِّمت صلاة للبابا المتنوّر فرنسيس والمطران المقدسي الشجاع منيب يونان رئيس الاتحاد اللوثري العالمي، إضافة إلى أمينه العام مارتن يونغا، تلاها الإعلان التاريخي الذي وقّعه البابا والمطران.
ولعلّ تلك الصلاة المشتركة كانت حدّاً فاصلاً للصراع العبثي الذي استمرّ لقرون من الزمن، وشكّل الاتفاق منعطفًا كبيرًا في حياة الكنيستين الكاثوليكية واللوثرية، وسجّل تاريخًا جديدًا إيجابيًا للعلاقة بينهما، حيث تمّ بموجبه إنهاء الصراع المعتّق الإلغائي والإقصائي والتحريمي والتشكيكي.
وهكذا اجتمعت الكنيستان بعد “الإعلان ” في ترجمة عملية للإيمان بالمحبّة ومعموديّة القلوب، علمًا بأنّ الحوار بين الكنيستين استغرق 5 عقود من الزمن (نصف قرن)، فقد ابتدأ مع انعقاد مجمّع الفاتيكان 1962 – 1965 وتُوّج بالاتفاق في العام 2016 .
ويستفاليا والمصالحة التاريخية
كنتُ قد سألت الصديق المطران منيب يونان الذي التقيته آخر مرّة في مؤتمر “القدس في الوجدان العربي” ، كيف توصّلتم إلى هذا القرار الجريء، ووضعتم كل الماضي الدموي التكفيري خلفكم؟ ومن أين استمديتم القوّة لوضع مقاصد المسيحية وروحها أمام جمهرة من الكاثوليكيين واللوثريين المتعصبين؟
فأجاب: لقد وضعنا الخلافات والاختلافات والتي تعود إلى القرون الوسطى وراء ظهورنا، وتركنا أمرها للدراسات الفقهيّة المستفيضة للّاهوتيين من الفريقين ومن يريد أن يدلو بدلوه فيها ، واتّفقنا على أنّه بالنعمة وحدها والثقة بالمستقبل يمكن تحقيق ذلك، خصوصًا الإيمان بما يعجّل الخلاص المسيحي، وهو أمر لا يعود لنا فحسب، فقد قبلنا الله وأعطانا الروح القدس الذي يجدّد قلوبنا ويدعونا للأعمال الصالحة… فحياتنا الجديدة مدينة للرحمة والغفران والتجديد، وهي عطيّة نتلقاها بالإيمان، ولا يمكن أن نستحقّها بأي وسيلة أخرى.
وبالعودة إلى إعلان المصالحة الكاثوليكية – اللوثرية، فقد ركّز على ما هو جامع وليس مفرّق، فعظّم تلك الجوامع وقلّص تلك الفوارق، بحثًا عن المشترك الإيماني الديني والإنساني، ومثل هذه النظرة لا تخصّ المسيحيين وحدهم، بل أنّها يمكن أن تنسحب على جميع المؤمنين باختلاف أديانهم، فما يجمع المؤمنون، مسيحيون أو مسلمون أو من أتباع ديانات أخرى سماويّة أو غير سماويّة، هو واحد يتجسّد في المُثل والقيم الإنسانية، التي تمثّل رسالة الأديان وروحانيّاتها. فقد شاءت الإرادة أن يحصل ما حصل، حين التقت الكنيستان الكاثوليكيّة واللوثريّة، واتفقتا على رفع جميع الإدانات والتحريميات السابقة، التي خطّها تاريخ الانقسام والتناحر.
وإذا كانت الانقسامات الدينية والطائفية والأثنية عنيفة وقاسية في الماضي، فإنّها لا تقّل عنفًا وقساوةً في التاريخ المعاصر، فبين بلدين عربيّين كان يحكمهما حزب واحد، ظلّت العلاقات مقطوعة لنحو ربع قرن (العراق – سوريا) ، بل إنّ مجرد اختلافات حدودية أو سياسية، كانت تؤدي إلى حروب وقطيعة وكراهية، بين العراق وإيران، العراق والكويت، المغرب والجزائر، ومصر والسودان، واليمن والمملكة العربية السعودية، وقطر والبحرين، وحماس وفتح، يضاف إلى ذلك، النزاعات المسلحة في لبنان وليبيا واليمن وسوريا وغيرها.
واختلفت بكين مع موسكو لدرجة التناحر، بالرغم من منطلقاتهما النظرية الواحدة، وادعاء كلّ منهما وصلًا بالماركسية، لكن كليهما لم يتورّع عن اللقاء مع “معسكر العدو” وتفضيله على اللقاء بـ” معسكر الصديق المختلف“، ونستعيد هنا الزيارات المكوكية التي قام بها كيسنجر إلى الصين، مناكفة للاتحاد السوفيتي في عهد الرئيس نيكسون العام 1972، وتطوّر العلاقات الصينية – الأمريكية، استنادًا إلى نظرية الضدّ النوعي.
وخلال العقود الأربعة الأخيرة ارتفعت نبرة العداء والكراهية بين من يزعم تمثيله للشيعة ومن يدّعي تمثيله للسنّة لدرجة الاحتراب، بسبب تاريخ مضى عليه أكثر من 1400 عام، والفريق الأول يقول بأحقيّة الخلافة، بعد وفاة الرسول محمد (ص) للإمام علي، والآخر يعتبر اجتماع السقيفة هو شكل من الشورى لاختيار الخليفة، وتُبنى على ذلك الاختلاف التاريخي سرديات وأوهام ومشكلات راهنة، أخذت تكبر مع مرور الأيام، وبعضها لا يربطها أحيانًا أيّة روابط مع القيّم الدينية والحضارية، ناهيك عن بعض الانحيازات والتفسيرات والتأويلات التاريخية.
وبلا أدنى شك، فثمّة عوامل إقليمية ودولية تؤجّجّ نار الصراع وتدفع العديد من البلدان العربية والإسلامية إلى إحترابات ونزاعات أهلية ومحلية، بل وفتن ظاهرة ومستترة أحيانًا، تعاظمت بشكل خاص بعد احتلال العراق في العام 2003، وحضور تنظيم القاعدة بقوّة، وفيما بعد تنظيم داعش وجبهة النصرة (جبهة فتح الشام) وأخواتها.
دروس التجربة
ثمّة دروس يمكن استلهامها عند مقاربة الاتفاق اللوثري – الكاثوليكي منها:
الدرس الأول – نزع فتيل الحرب المُستعرة لنحو 500 عام؛ الدرس الثاني – تحقيق الطمأنينة الإيمانية ومحاولة معالجة الآثار النفسية على أتباع الطائفتين؛ الدرس الثالث – الحق في الاجتهاد وممارسة الشعائر الدينية والطقوس بحريّة دون إكراه أو تكفير؛ الدرس الرابع – الابتعاد عن كل ما له علاقة بالماضي، وما سبّبه من خلافات وصراعات دموية، والاهتمام بالحاضر، بعيدًا عن الصراعات التاريخية مع تأكيد الإيمانية المسيحية المشتركة.
وهذه الدروس تصلح أن تكون دليلًا ومرشدًا أمام جميع المؤمنين والذين يهمّهم نشر قيم السلام والتسامح والمشترك الإنساني بين البشر، فذلك سؤال الضرورة، فلمّا حانت لحظة الحقيقة وهي لحظة تَسامٍ وتطهّرٍ وروحانيّةٍ، توجّه المطران الشجاع منيب يونان مدفوعًا بضميره وبالمحبة وبرسالة التآخي، التي يؤمن بها ليلتقي قداسة البابا بنيدكتوس السادس عشر، ليطلعه على وصول الحوار إلى نتائج مثمرة وطيّبة، حيث نضجت ظروف إنجاز إعلان تاريخي من النوع الذي ستحفظه الأجيال، خصوصًا وقد توخّى الوصول إلى المصالحة التي طال انتظارها، وتأكيد وحدة الصف المسيحي في مفصل من مفاصله الصراعية المضنية.
ومثل هذا الموقف التاريخي، حريّ بالنخب الفكرية والثقافية والسياسية في الحكم وخارجه، وفي بلدان الأمم الأربعة وما حولها وما في جوارها، أن تستلهمه ببحثها عن تعظيم الجوامع وتقليص الفوارق بحلّ العقد التاريخية، سواء بتسويات معينة ترضي الفرقاء أو الابتعاد عنها وجعلها في ذمة التاريخ.
كيف السبيل للوصول إلى ويستفاليا؟
في البحث عن السبل للوصول إلى ويستفاليا، يمكننا العودة إلى مبدأ الحوار، لنتعرّف على مطالب وحقوق وطموحات بعضنا البعض، ويمكن البدء من المشكلة القومية في المنطقة، وحديثي هذا لا يتضمّن لا من بعيد أو من قريب “إسرائيل”، التي هي كيان عنصري مغتصب أُنشأ على حساب الشعب العربي الفلسطيني وحقوقه التاريخية.
المشكلة تخصّ الأمم الأربعة، وإذا كان للعرب عدّة دول وللفرس دولتهم وللترك دولتهم، وإن كانت هذه الدول متعدّدة الثقافات والقوميات والأديان كبرت أم صغرت، إلّا أنّ الكرد هم الأمة الوحيدة المجزأة والمحرومة من حقها في قيام دولة، علمًا بأنّها تمتلك كل مقوّمات الأمة، لكنّها لا تمتلك دولة، كما لم تتمكّن من حقّها في تقرير مصيرها، ابتداءً من معاهدة سايكس – بيكو المبرمة في 16 أيار / مايو 1916.
وكعربي ويعتزّ بعروبته مثلما أتمنى أن تحقق الأمة العربية يومًا طموحها في الوحدة الكيانية، فإنّني في الوقت نفسه أقف مع الأمّة الكردية في تحقيق طموحاتها في الوحدة القومية الكيانية، وأقول ذلك ليس منّة أو هبة أو مجاملة، بل لأنني مؤمن إيمانًا صادقًا بحق الأمم والشعوب في تقرير مصيرها، وستكون عروبتي وقيمي الإنسانية ناقصة ومبتورة ومشوّهة، إن لم أتّخذ هذا الموقف المنسجم مع قيم حقوق الإنسان. ولا بدّ هنا من الإشارة إلى أنّ أي تغييرات جيوبوليتيكية لا ينبغي أن تكون على حساب المحيط الإقليمي ومصالحه المشتركة وتطلّعات شعوبه في التنمية والتقدّم. وإذا كان الشعب الكردي المجزّأ في 4 دول أساسية في المنطقة قد اتّخذ أشكالًا مختلفة، طريقًا لتلبية حقوقه في إطار حق تقرير المصير، فإنّ ذلك لا يؤثر على النظرة الاستراتيجية للحقوق التاريخية.
لقد تبنّى كرد تركيا مبدأ “الأمة الديمقراطية”، وتلك هي أطروحة عبد الله أوجلان APO، الزعيم الكردي المغيّب منذ ربع قرن والتي لخّصها في كتابه “الأمة الديمقراطية”، استنادًا إلى الفكرة الديمقراطية المعاصرة، بوصفها حلًّا للمشكلة القومية، مقدمًا نموذجًا جديدًا يرتكز على قواعد قانونية واجتماعية واقتصادية وثقافية.
وهذا النموذج يمكن أن يتحقق وفقًا لطريقتين؛ الأولى: طريق الوفاق مع الدولة القومية من خلال “الدستور الديمقراطي” حسب أوجلان، واحترام الإرث التاريخي – الاجتماعي للشعوب والثقافات، وهذا يعني تخلّي الدولة القومية الحاكمة عن سياساتها في الإنكار والإبادة.
أما الثاني: طريق مشروع أحادي لشبه الاستقلال الديمقراطي، إيمانًا بحق الكرد بالتحوّل إلى “أمّة ديمقراطية”، وهو حلّ اضطراري إذا ما وقفت الدولة القومية ضدّ الحلّ الأول، وإن كان الثمن باهظًا، فعلى الكرد حسب أوجلان، ألّا يتقاعسوا في تحقيق تحوّلهم وتطوّرهم إلى أمّة ديمقراطية، بكلّ أبعادها على خلفية الدفاع الذاتي.
وإذا كان كرد العراق قد اختاروا الفيدرالية صيغة للحل الديمقراطي في إطار الدولة القومية، حيث اعترفت فيها الأطراف الأخرى، وتم تكريسها في الدستور الدائم الذي جاء فيه “أنّ جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة”، وحسبما ورد في الدستور، فإنّه ضامن لوحدة العراق، الذي هو بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب…
وبغض النظر عن الألغام التي احتواها الدستور والمثالب والثغرات الكثيرة التي تضمّنتها، والتي ساهمت في حالة الفوضى وعدم الاستقرار، لاسيّما بنظام المحاصصة الطائفية – الإثنية، إلّا أنّه من الناحية العملية يُعتبر اعترافًا نظريًا بالحل الديمقراطي في إطار الدولة القومية، وهو بخطوطه العريضة نال موافقة الكرد العراقيين، وهو خيار يتناسب مع تطوّر القضيّة الكردية قانونيًا وسياسيًا وثقافيًا.
وإذا كانت الرغبة في الاستقلال وحق تقرير المصير بما فيه تكوين كيانية خاصة قائمة، حيث تمّ التعبير عنها بالاستفتاء الكردي الذي حصل في 25 أيلول / سبتمبر 2017، فإنّ هذه الرغبة يحكمها توازن القوى السياسية العراقية وتطوّرها، بما فيها الكردية باختيار صيغة جديدة أو تطوير الصيغة القائمة.
كرد سوريا
وفي سوريا احتاج الكرد إلى تفاهمات طويلة مع الحكومة المركزيةK للتوصّل إلى صيغة تخصّ الإدارة الذاتية، وللأسف فإنّ مثل هذه الصيغة لم تولد في الظروف السلمية الطبيعية، بل جاءت نتيجة للحرب والتداخلات الخارجية التركية والأمريكية، فضلًا عن الوجود الإيراني والروسي، الذي كان بموافقة الحكومة السورية، لاسيّما في مواجهة قوى الإرهاب، داعش وأخواتها، ويتطلّب الأمر خطوات قانونية وسياسية لإقرار المواطنة المتكافئة والمتساوية، وأخذ المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بنظر الاعتبار.
كرد إيران
وفي إيران فحتى الآن يسعى كرد إيران لتحقيق المواطنة والمساواة والاعتراف بوجودهم كقومية، وحقهم في التمثيل السياسي، إذ لا يكفي القول أنّ الناس متساوون كأسنان المشط، لا فرق بين عربي وأعجمي إلّا بالتقوى، بل تحويل ذلك إلى نصوص دستورية وقانونية يستطيع فيها الكرد، أن يعبّروا عن طموحهم السياسي، علمًا بأنّ الدستور الإيراني ينصّ على أن يكون رئيس الجمهورية إيراني الأصل، ويحمل الجنسية الإيرانية، ويرتفع الصوت القومي الفارسي، حتى وإن كان مغلفًا بطلاء ديني أو مذهبي، لكنّه بلا أدنى شك، يمثّل طموحًا أيديولوجيًا قوميًا كدولة كبرى من دول الإقليم، مثلما هي تركيا التي تغلّف طابعها القومي الأيديولوجي أحيانًا، بتلوينه بصبغة دينية أو طائفية.
روافد ويستفاليا: وثيقة الأخوة الإنسانية
للوصول إلى صيغة ويستفاليا مشرقية جديدة منسجمة مع ميثاق الأمم المتحدة واللوائح الدولية لحقوق الإنسان، ومتفاعلة مع القيّم المشتركة، لا بدّ من البدء بالحوار دون شروط، وهذا الحوار يتّخذ أبعادًا مختلفة، أنّه حوار إسلامي – مسيحي مثلًا، وحوار سني – شيعي وحوار عربي – كردي وحوار عربي – إيراني وحوار عربي – تركي، وحوار كردي على صعيد الإقليم، عرب، ترك، فرس.
الحوار لا ينبغي أن يتّخذ شكلًا فوقيًا، بل عمقًا تحتيًا، حوار للنخب والفاعليات السياسية والثقافية والاجتماعية، فعلى الرغم من أهمية “وثيقة الأخوّة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك“، إلّا أنّها تحتاج إلى تفعيل، بحيث تتحوّل إلى برامج وخطط عمل وعلاقات ثقافية واجتماعية، وإقرار بالتنوّع والقبول بالتعددية والحق في الاختلاف، كما ينبغي أن تأخذ بُعدها القانوني والحقوقي والأخلاقي، وكذلك تجسيدها التربوي والتعليمي، في إطار من الحريّة والمساواة والشراكة والمشاركة، لاسيّما في البلدان المتعددة الثقافات، على الصعيد المجتمعي أم على الصعيد الفردي.
وبالعودة إلى الوثيقة نقول لقد تمّ توثيقها من قبل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا فرنسيس، في 4 شباط / فبراير 2019، في دولة الإمارات العربية (أبو ظبي)، والتي اعتُبرت نداءً لكل ضمير حي ينبذ العنف البغيض والتطرف الأعمى، وهي “دعوة للمصالحة والتآخي بين جميع المؤمنين بالأديان، بل بين المؤمنين وغير المؤمنين، وكل الأشخاص ذوي الإرادة الصالحة”، كما جاء فيها، بما يعزّز مبادئ التسامح والإخاء، ويوحّد القلوب ويسمو بالإنسان.
وكان العالم قد احتفل لأول مرة باليوم العالمي للأخوّة الإنسانية، بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 ديسمبر / كانون الأول 2020، اعتبار 4 فبراير (شباط) اليوم العالمي للأخوّة الإنسانية، وذلك استجابة لمبادرة تقدّمت بها كل من دولة الإمارات العربية المتّحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين.
جدير بالذكر أنّ أبو ظبي كانت قد استضافت في 4 فبراير (شباط) 2019، المؤتمر الذي نظّمه مجلس حكماء المسلمين، بهدف تفعيل الحوار مع الآخر للتعايش والتآخي بين البشر وتعزيزه عالميًا، وهو المؤتمر الذي وضع ضمن أهدافه التصدي للتعصّب ووليدة التطرّف، ولا سيّما الفكري، وإذا ما انتقل الأخير إلى الفعل سيصبح عنفًا، وحين يضرب عشوائيًا يصير إرهابًا، وذلك بتأكيد علاقات الأخوّة الإنسانية، التي ينبغي أن تُرسى على أسس جديدة، قوامها احترام الاختلاف والتمايز والكرامة الإنسانية، من أجل العيش المشترك والسلام العالمي، وهو أمر يقع على عاتق القيادات السياسية والمؤسسات الدينية والمنظمات العالمية والمحلية لكل من المسيحيين والمسلمين، كما جاء في نص الوثيقة.
وسلطت الوثيقة الضوء على عدد من الثوابت كما أسمتها، من أهمها أنّ التمسك بالتعاليم الدينية الصحيحة، التي تدعو إلى قيّم السلام والتعارف والأخوّة والعيش المشترك، الذي من شأنه أن يعزّز قيّم الحريّة، ولا سيّما حريّة المعتقد والتعبير والتفكير لكل إنسان، فضلًا عن الإيمان بالتعددية والمواطنة المتساوية والعدل للجميع، والاعتراف بحقوق المرأة والطفل والمسنّين والضعفاء ، ناهيك عن رفض الإرهاب والاعتداء على دور العبادة.
وبقراءة ارتجاعية إلى حيثيّات الوثيقة ارتباطًا بكلمات شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان، ندرك الرسائل المهمّة التي حاول كل منهما وعلى نحو متكامل توجيهها، وكانت دعوة الأزهر قد تضمّنت أربعة أركان:
الركن الأول: الموجّه إلى المسلمين بالانفتاح على المسيحيين، مذكرّةً بالعلاقات التاريخية بينهم منذ فجر الإسلام.
الركن الثاني: الموجّه إلى مسيحيّي الشرق بالقول: أنتم جزء من هذه الأمة… وأنتم مواطنون كاملوا الحقوق والواجبات… ولستم “أقليّة”.
الركن الثالث: الموجّه إلى أتباع الديانتين بالدعوة إلى الوحدة باعتبارها “الصخرة التي تتحطم عليها المؤامرات”.
الركن الرابع: الموجّه إلى المسلمين في الغرب، بدعوتهم إلى الاندماج إيجابيًا في مجتمعاتهم، بالمحافظة على هويّاتهم الدينية من جهة، والحفاظ على قوانين المجتمعات التي يعيشون فيها من جهة أخرى.
وكانت دعوة البابا فرنسيس للأخوّة الإنسانية بقوله : إنّ كل الناس متساوون في الكرامة، فلا نستطيع عبادة اللّه دون احترام كرامة كل إنسان، وحقوق كل فرد، لأنّ اللّه لا ينظر إلينا بعين التفرقة التي تُقصي، بل بعين حاضنة للجميع، وركزّ البابا على حرّية المعتقد وحق الاختلاف، معتبرًا التعدّديّة مشيئة الحكمة الإلهية، مشيرًا إلى أهمّية العيش معًا، لمواجهة التهجير والجوع والحروب والأوضاع غير الإنسانية.
الوثيقة التي وقعها شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان، هي أول وثيقة في التاريخ، توقّع بين مسيحيين ومسلمين بهذه الرمزية على نحو متكافئ، أساسها الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والدفاع عن قيم السلام والتسامح؛ وهي رسالة حضارية ضد الكراهية في لحظة حساسة من لحظات التأمل في المصير الإنساني، الذي استوجب شحذ الأمل وصولًا إلى كسر الحواجز والتابوهات بين المجتمعات وأتباع الديانات والثقافات المختلفة، وتعزيز التواصل حول القيم والحقوق الإنسانية، لاسيّما بالحوار والتفاعل.
والاحتفال من جانب الأمم المتحدة، يُعدُّ اعترافًا كونيًا للإنجاز التاريخي الذي حققته الوثيقة بمضامينها الإنسانية، الأمر الذي يستوجب نبذ التصورات النمطية إزاء الآخر، والعمل على بناء الجسور للتعاون والتضامن ضد العنصرية والتمييز والاستعلاء والاستتباع، وجميع مظاهر عدم المساواة والتنكر لحقوق الإنسان، ولعل منح جائزة زايد للأخوّة الإنسانية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريس مناسبةٌ، لإعادة تأكيد الفاعلية للمشتركات الإنسانية وتعظيم الجوامع وتقليص الفوارق واحترام الخصوصيات، في إطار قيم السلام ونبذ العنف، وهو ما يحتاج العالم إلى تفعيله في جميع الثقافات والمجتمعات ولدى أتباع الأديان المختلفة، بابتكار وسائل جديدة ومبادرات مشتركة بحيث يستطيع الجيل الجديد استلهامها من خلال مناهج تربوية ودراسية ومجتمعية وقانونية تُعلي من شأن ثقافة السلام والتسامح والعدل والمساواة والشراكة والمشترك الإنساني.
الشيعة – السنة
أمّا القضية الثانية فهي الفتنة الطائفية الشيعية – السنية، التي يُراد إيقاظها بحيث تتحوّل إلى حالة احتراب وصراع إقصائي – إلغائي لا حدود له، علمًا بأنّ المشتركات بين الشيعة والسنة تزيد عن 80% من أصول الدين وفروعه، فاللّه واحد وكتبه واحد، وباستثناء اجتهادات بعض الفقهاء، وهي موجودة في كلّ الأديان، لا توجد ثمّة خلافات كبيرة، إلّا إذا أُريد العيش في التاريخ أو الغرق في تفاصيله، فأنّ تترك مشكلات الحاضر وقيم الأرض للتصارع حول قيم السماء بحيث يصبح الاصطفاف بين عيد الغدير أو اجتماع السقيفة، وننسى العدو الذي يدقّ على الأبواب، ويدنّس الحرمات والمسجد الأقصى ويبيد غزّة، ونحن نتصارع على أحداث مضى عليها أكثر من 1400 عام ولا يمكن إعادتها، بل يمكن استعادتها بأخذ الدروس والعبر الضرورية منها.
الحوار العربي – الكردي
والأمر يشمل فكرة حوار عربي- كردي أو حوار مثقفي الأمم الأربعة أو ما أطلق عليه سمو الأمير الحسن بن طلال. حوار جامع لأعمدة الأمم الأربعة، وثمّة حوار تمّت الدعوة له في المغرب تحت عنوان “حوار أمازيغي – عربي“، بعد إعلان الملك محمد السادس عن الاحتفال بيوم رأس السنة الأمازيغية الذي يوافق يوم 13 كانون الثاني / يناير من كلّ عام، واعتباره يوم عطلة وطنية، أسوة بعيد رأس السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية.
وهدف الحوار هو استشراف آفاق حلول للمشكلات وبحث جاد في أسباب الأزمات وسبل تجاوزها واختيار الوسائل المناسبة لمعالجتها، ولذلك فهو يختلف عن المجاملات الشكلية والمخاطبات الدبلوماسية الناعمة، تلك التي تتجنب بحث الإشكالات والخلافات بواقعية وعدم القفز فوقها لأن ذلك لن يوصل الحوار إلى مبتغاه المطلوب، بل يراكم المشكلات ويزيدها تعقيدًا واشتباكًا، وحسب المهاتما غاندي فالوسيلة جزء لا يتجزأ من الغاية، مثل البذرة إلى الشجرة، إذ لا غاية شريفة بدون وسيلة شريفة.
والمطلوب من الحوار بادئ ذي بدء توفير مناخ صحي لإشاعة روح الثقة وبالتالي التدرّج في تشخيص جوانب الأزمة والبحث في المشتركات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمواجهتها ، وهذا يقتضي تحريره من الاسقاطات المسبقة قوميًا أو دينيًا أو أيديولوجيًا، لاسيّما بالعودة إلى علاقات الشعوب والمجاميع الثقافية بعضها مع البعض الآخر، في إطار البلد الواحد أو على صعيد دول الإقليم في مشرقه ومغربه، وذلك بتجاوز الثقافة السياسية السائدة القائمة على التهميش والإلغاء وعدم الاعتراف بالآخر، سواء على المستوى الوطني أو على الصعيد الإقليمي الخارجي، ويتطلب ذلك النهوض بالرسالة الحضارية لفكرة الحوار من خلال كونه استحقاقًا لا غنى عنه وضرورة ماسة وليس ترفًا فكريًا أو نزوة عابرة، والأمر يبدأ بالمراجعة للمشتركات والمختلفات، وللإيجابيات والسلبيات وتأثير دائرة التلاقي والتفاعل بحيث تكون مساحة الحوار شاسعة ومستمرة ودائمة، ولن يتحقق ذلك إلا بالمصارحة والشفافية والنقد المتبادل.
ويستفاليا والنخب الفكرية والثقافية: مبادرات شخصية
في الأطر الثلاث، كنت قد بادرت إلى:
أول حوار عربي – كردي قد نظّم في لندن العام 1992 بحضور 50 شخصية عربية وكردية، في إطار مبادرة حقوقية شقت طريقها إلى “المنظمة العربية لحقوق الإنسان“، التي كنت أتشرّف برئاستها، وكنت قد تلمّست ذلك، بعد ويلات ومآسي لا حصر لها، خصوصًا بما تعرّض له الكرد من انتهاكات، سواء في حملة الأنفال أو في قصف حلبجة بالسلاح الكيماوي (1988)، الأمر الذي كاد البعض أن يكفر بفكرة الحوار الذي تصدّع ركنه وتزعزع مفهومه، وكانت مثل تلك المبادرة بمثابة ردّ اعتبار وسباحة ضد التيار .
كما كان أول حوار بين مثقفي الأمم الأربعة (العرب والترك والفرس والكرد) قد انتظم لأول مرة في تونس 2016 حين استجاب “المعهد العربي للديمقراطية” لمبادرة كنت أروّج لها وأدعو إليها لأكثر من عقد من الزمان، كما أشارت إليه الحركة الثقافية في انطلياس (العام 2017) لمناسبة تكريمي كعلم من أعلام الثقافة في العالم العربي ولبنان .
وتبعها قناعة من “منتدى الفكر العربي” الذي تحمّس للمبادرة، وكان ذلك في ندوة اتخذت اسم ” أعمدة الأمة الأربعة” في 22 تموز (يوليو) 2018، والمقصود بذلك العرب، الكرد، الترك والفرس، وهي مواصلة لندوة حول “الحوار العربي – الكردي” في 1 آذار (مارس) 2018، حيث صبّت بذات الاتجاه وجميع تلك المبادرات اتخذت من الحوار وسيلة ضرورية للتفاهم والتواصل.[22]
وعلى صعيد آخر كنت قد دعوت إلى تشريع مشروع قانون لتحريم الطائفية وتعزيز المواطنة منذ الثمانينيات، وبادرت إلى صياغته وعرضه للمناقشة لنخب وجهات حقوقية وفكرية وثقافية.[23].
كما ساهمت في بلورة رؤية دفاعية عن المسيحيين بعد تعرّضهم لحملة تهجير وانتهاك لحقوقهم، إثر موجة الربيع العربي، وأصدرت 3 كتب آخرها بعنوان “أغصان الكرمة – المسيحيون العرب”، مركز حمورابي، بغداد / بيروت، 2015. إضافة إلى المجموعات الثقافية الأخرى، مثل الإيزيديين والصابئة المندائيين.
وبادرت إلى نشر ثقافة المواطنة المتساوية وتنظيم عدد من المؤتمرات بشأنها والتربية عليها.
ماذا يعني غياب ويستفاليا؟
ثمّة أسئلة للشك وليست لليقين، وهذه تتعلّق بالعلّة والمعلول، والسبب والنتيجة، إنها أسئلة قلق وليس طمأنينة، لأن استمرار غياب مشروع حضاري نهضوي للمنطقة يعني المزيد من الصراع والتشظي والاحتراب والنفوذ الخارجي، فضلًا عن الأثمان الباهظة على صعيد تعطيل التنمية وتعثّر الإصلاح والتخلّف عن مواكبة العالم والانشغال بالحروب والصراعات الداخلية والإقليمية.
وبمجرّد تقديم جردة حساب لحصاد الحروب ندرك حقًا مدى الفداحة، فقد كان دفعت دول الإقليم الذي نعيش فيه والذي يضمّ الأتراك والفرس والكرد والعرب، عدّة ملايين من الضحايا وما يزيد عن 12 تريليون دولار في التقديرات غير المبالِغة خلال العقود الأربعة الماضية، لعلّ أبرزها وأهمها الحرب العراقية – الإيرانية 1980 – 1988 وتداعياتها على عموم دول المنطقة، وخصوصًا بعد مغامرة الحكومة العراقية بغزو الكويت 1990، وحرب قوات التحالف ضدّ العراق العام 1991، ومن ثمّ فرض حصار دولي جائر عليه دام 12 عامًا، وبعدها غزو العراق واحتلاله العام 2003، واندلاع موجة تعصّب وتطرّف وعنف وإرهاب في المنطقة، ما تزال تداعياتها مستمرة، ليس على العراق فحسب، بل على عموم دول الإقليم.
ولعلّ ذلك ليس سوى الوجه الآخر لتعويم التنمية أو تعطيلها على أقل تقدير وعرقلة خطط الإصلاح التي لا يمكن الحديث عنها إلّا في ظل أجواء الاستقرار والسلام، ﻓ “الحروب تولد في العقول” ولذلك ينبغي “تشييد حصون السلام في العقول أيضًا“، حسب دستور اليونسكو، ولأنّ وظيفة النخب الفكرية والثقافية بشكل عام التوجّه إلى الإنسان ومخاطبة عقله، فلا بدّ لها إذًا أن تتحرّك لتقديم رؤية نقيضة للحرب على الرغم من الخراب والدمار وثقافة العنف، وذلك عبر تغليب العقل ومنطق الحوار والتفاهم والتعاون والمصالح المشتركة.
ومثل هذه النظرة المستقبلية شغلت مثقفين من بلدان عدّة تلمّسوا بتجاربهم وكلٌ من موقعه أهمية الحوار خارج دائرة الاشتباكات الأيديولوجية والنزاعات الدينية والطائفية والاحترابات الأثنية والاستقطابات الأنانية الضيقة، لأنها تقوم باختصار على أن الأمم والشعوب التي تعيش في المنطقة والتي تعاني من توتّرات ونزاعات داخلية وصراعات إقليمية وخارجية، تحتاج إلى إعادة بناء علاقاتها مع بعضها لتنميتها بروح القيم الإنسانية التي تمثّل المشتركات بين البشر، بعيدًا عن محاولات فرض الهيمنة والاستتباع والتدخل بالشؤون الداخلية ، تلك التي أضرّت ضررًا بليغًا بجميع شعوب المنطقة.
وإذا توقّفنا عند الحروب والصراعات والنزاعات التي تعيشها دول الإقليم، فسنراها حروبًا مركّبة سياسية واقتصادية وأيديولوجية حتى وإنْ حملت في حقيقتها “مصالح” أو “أهداف” قوميّة ودينية وطائفية جيوسياسية ونزعات للتسيّد وفرض الإرادة، سواء حدثت بصورة مباشرة أم بالواسطة وبالتداخل والتناظر مع مصالح دولية أحياناً، وليس بعيداً عنها الدور “الإسرائيلي” العدواني المستمر.
فهل ثمّة فرصة لأمم الإقليم لتعزيز الروابط فيما بينها والنهوض بمستلزمات التحدّي الذي يواجهها، خصوصًا وأن هناك استهدافًا شاملًا لها جميعًا دون استثناء ؟ ثم كيف يمكنها استثمار اللحظة التاريخية والتقاط ما هو جوهري ومستقبلي لبناء العلاقات وفقاً لقيم ومبادئ كونية جامعة قوامها: الحرية والسلام والتسامح والمساواة والعدالة والشراكة والمشاركة واحترام الخصوصيات والهوّيات الفرعية، وتلك جوامع إنسانية لبني البشر، فما بالك بالنسبة لشعوب المنطقة.
روافع ويستفاليا
نطرح هنا سؤالًا محوريًا يتعلّق بالوسيلة المناسبة لتحقيق هدف إبرام ويستفاليا مشرقية، بناء السلام وإدامته وتطويره عبر الحوار، لاسيّما بنشر ثقافة السلام واللّاعنف والتسامح.
وإذا كان هذه القيم حضارية وواقعية على المستوى الكوني، فهناك خمس رافعات أساسية لتجسيدها في الواقع العملي، كي ما تستطيع مجتمعاتنا، بل والعالم أجمع الخروج من غلواء التعصّب والتطرّف والإقصاء والتهميش والعنف والإرهاب. ولن يتحقق ذلك دون توفير تربة خصبة لبذر بذوره، وتعميق الوعي الأخلاقي والحقوقي والقانوني والاجتماعي بأهميته، بل بضرورته، وذلك من خلال الإقرار بالتنوّع والتعددية وقبول حق الاختلاف والمغايرة والتعايش واحترام الآخر والتربية على ذلك، لاسيّما في ظلّ “حكم القانون“، سواءً كان ذلك على المستوى الفردي أم الجماعي أم على مستوى الحكومات والدول، خصوصًا بتوفير بيئة سلمية ولا عنفية ينمو فيها المشترك الإنساني ومبادئ المساواة والتآخي بين البشر.
ولعلّ الرافعات الخمس التي نتحدّث عنها هي أكثر ما نفتقده في عالمنا العربي ودول الإقليم.
الرافعة الأولى: البيئة التشريعية والقانونية، إذْ أن عدم وجود قوانين وأنظمة راعية لمبادئ الحوار والسلام والتسامح، وكذلك رادعة لمن يخالفها، سواءً إزاء الأديان أم القوميات أم الثقافات، سيؤدي إلى تفقيس بيض اللاسلام واللّاتسامح، ويغذي التعصّب والتطرّف ووليدهما العنف والإرهاب، الأمر الذي يقود إلى احتدامات وصراعات ونزاعات مسلحة وحروب، بهدف إلغاء وإقصاء وتهميش الآخر، وفرض الهيمنة عليه.
الرافعة الثانية: البيئة التعليمية والتربوية، ولا شكّ أن غياب منظومة الحوار والسلام والتسامح عن المناهج والأساليب التربوية والتعليمية سيقود إلى التعصّب وعدم الاعتراف بالتنوّع والتنكّر للتعدّدية، خصوصاً بالنظرة القاصرة إلى الآخر والمشفوعة بتبرير الممارسات التمييزية الاستعلائية، تلك التي تخلق ردود فعل حادة وتقود إلى تشجيع عوامل الاحتراب والشعور بالاستلاب، لاسيّما من جانب المجموعات المستضعفة والمهضومة الحقوق، ويعتبر حقل التربية والتعليم أنجع الوسائل للحدّ من ظواهر عدم التسامح والتمييز، ولعلّ الخطوة الأولى على هذا الطريق تعليم الناس وتربيتهم على حقوقهم وحرياتهم التي يتشاركون فيها وتأكيد عزمهم على حمايتها.
يقول آينشتاين “يجب علينا إعادة كتابة الكتب والمناهج المدرسية، فبدلًا من تمجيد النزاعات والأحكام المسبقة القديمة، يجب أن يملأ نظامنا التعليمي بروح جديدة. تعليمنا يبدأ في المهد: تتحمّل أمهات العالم بأسره مسؤولية تعليم أطفالهم أهمية حفظ السلام”.
وفي رسالة إلى سيغموند فرويد بعد تكليفه من جانب عصبة الأمم والمعهد الدولي للتعاون الفكري في باريس كتب يقول :
“إنّني على ثقة من أنّك سوف تكون قادرًا على لفت الانتباه إلى طرق التربية القادرة، وبطريقة غير سياسية إلى حدّ ما على إزالة العقبات النفسية التي يحس بها الذين يفتقرون إلى الخبرة في مجال علم النفس، ولكن يمكنهم الحكم على ارتباطاتها وصلاتها وقدرتها على التغيير”.
الرافعة الثالثة: البيئة القضائية، فالقضاء إذا كان مهنيًا ومستقلًا ومحايدًا في ظلّ حكم القانون وتطبيق مبادئ العدالة، فإنه سيلعب دورًا إيجابيًا في الإقرار بحق الاختلاف والمساواة ونصرة المظلوم وإحقاق الحق وترسيخ قيم العيش معًا.
الرافعة الرابعة: البيئة الإعلامية وهي سلاح ذو حدين، فبالإمكان أن يكون الإعلام عاملًا مساعدًا ومهمًا في نشر قيم الحوار والسلام والتسامح ومبادئها وتعظيم الجوامع والمشتركات، أو في الترويج بعكسه لنقيضها، أي لنشر ما يغذّي الكراهية والأحقاد وتضخيم الفوارق والمختلفات.
الرافعة الخامسة: البيئة الاجتماعية والمجتمعية التي يمكن أن يلعب فيها المجتمع المدني دورًا إيجابيًا في نشر ثقافة الحوار والسلام والتسامح، باعتبار مؤسسات المجتمع المدني راصدًا ورقيبًا للممارسات الحكومية إزاء خرق وانتهاك هذه المبادئ وقيمها، ناهيك عن إمكانيتها في لعب دور قوة اقتراح وهذا هو المهم، مثلما يمكن أن تكون قوة احتجاج أيضًا، وهذا يتطلّب منها أن تدرك مسؤوليتها وتمارسها فعليًا كشريك ومكمّل لا غنى عنه لتحقيق خطط التنمية، إذا استطاعت تقديم مشاريع قوانين ولوائح وأنظمة لترسيخ وتعزيز هذه القيم والمبادئ، وتنقية مناهج التربية والتعليم والخطاب الإعلامي والديني والسياسي، من مظاهر اللّاتسامح السائدة، وبخاصة التي تبرّر التمييز وعدم المساواة.
ولكي تتوفر مثل هذه الأرضية لا بدّ من فهم مشترك لهذه الأفكار، أي الحوار والسلام والتسامح، وذلك بتنزيهه عن الفكرة الدارجة التي تعني وجود طرفين أحدهما قوي والآخر ضعيف أو تلك التي تصوّر معارضتها لمبادئ العدالة وكأنها تعني غضّ الطرف عن الارتكابات والانتهاكات لحقوق الإنسان. كما يتطلب الأمر الاعتراف بحقوق الغير، ولاسيّما معاناة الفئات المستضعفة .
وهذا يعني إنصاف الأفراد والجماعات التي تعرّضت حقوقها للانتهاك، وذلك بعيدًا عن الاعتبارات المصلحية والنفعية السياسية والشخصية، من خلال الإقرار بمعاناة فئات وشعوب وأمم وأديان وطوائف وجماعات مستضعفة، تعرّضت بسبب اللّاتسامح وهضم الحقوق إلى مآسي كبيرة، لحقت بها جرّاء حروب وأعمال إبادة وقمع وإرهاب واستباحات باسم “القومية” أحيانًا أو “الدين” أو “الطائفة” أو “المذهب” أو “مصالح الكادحين” أو غير ذلك من المزاعم الأيديولوجية.
من النزاع إلى الشراكة
نحتاج بعد ذلك إلى جهود كبيرة لتلطيف الأجواء والانتقال من “النزاع إلى الشراكة” تعزيزًا لقيم العدالة والسلام وحقوق الإنسان، إضافة إلى الاستفادة من العبر التاريخية بعدم الوقوف عند أخطاء الماضي وتشبّث كل طرف بأفضلياته ومزاعمه بامتلاك الحقيقة، ويتطلّب ذلك الاعتراف بالأخطاء وتجاوزها واستشراف أفق المستقبل وتلمّس ملامحه.
ولا بدّ من نبذ جميع أشكال الكراهية وتضميد الجراح وتحقيق الوحدة الوطنية تمهيدًا للتفاهمات بين دول الإقليم عبر العمل المشترك في إطار القيم الإنسانية المدافعة عن السلام والعدالة.
وبتقديري أن أي تقارب لا بدّ أن يجسّد روح التآخي والمحبة والوحدة والإصلاح. وهنا تكمن أهمية الحوار العقلاني الذي يأخذ المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة ويبحث عن نقاط اللقاء تمسّكًا بأهداب الوحدة والمشتركات الإنسانية.



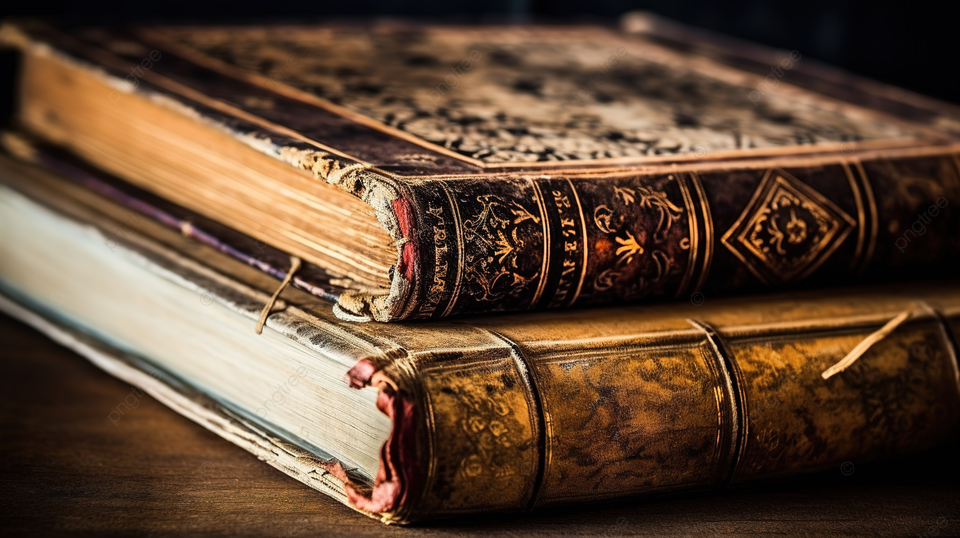
مفكر كبير …يفكك اشكاليات مَشكلة كبرى دفعت البشرية اثمان باهضة بسببها
من أجمل ما قرأت منذ زمن طويل!